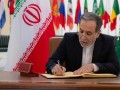الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
سقوط شعبي لمشروع دويلة «حزب الله»!
سقوط شعبي لمشروع دويلة «حزب الله»!

بقلم - حنا صالح
«وينيي الثورة»؟ و«شو عملت»؟
هذان السؤالان ومثلهما أسئلة كثيرة، كانت تُطرح منذ فترة وبإلحاح، وكثيراً ما كان ذلك ينمّ عن يأس، ومرات عن سوء نية، ويُتبعه السائل بتأكيده أن الثورة كانت هباءً؛ فكل شيء ضاع، والبلد خلص، والدليل أن الناس تُركت إلى مصيرها رغم تراكم الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتداعيات اقتلاع لبنان، والخسائر النوعية التي يستحيل تعويضها سريعاً وهي الناجمة عن تهجير الكفاءات والخريجين الشباب!
صباح يوم الانتخابات تساءلت في مقالتي في «الشرق الأوسط»، هل الرهان على التصويت العقابي ممكن؟ طرحت السؤال رغم ثقتي بأن ثورة «17 تشرين» أدخلت وعياً عميقاً شمل كل البيئات والشرائح والمناطق، فغادر الناس مقاعد المتفرجين وتحول المواطن لاعباً سياسياً. ولم يكن ترفاً تبني الاجتماع اللبناني شعار «كلن يعني كلن»، فينبغي محاسبة المسؤولين عن الكوارث المدمرة. لقد أدرك الناس من الأيام الأولى للثورة، أن لا شيء حدث بالصدفة، فالمتسلطون أداروا الظهر لمصالح الناس والبلد، واستندوا في تحكمهم إلى «قانون العفو عن جرائم الحرب»، فلم يحاسب أحد. وبمقابل مصالح خاصة تعاموا عن اختطاف «حزب الله» للدولة ولقرار البلد، وانخرط الجميع في لعبة الحكم وفق البدع والفتاوى التي حلت مكان الدستور..
وكانت قد تعممت تقارير إعلامية التقت على التشكيك بجدوى العملية الانتخابية، بينها ما نشرته «الفيغارو» بأنه «لو لم تتأكد الأوليغارشية الطائفية من عودتها إلى السلطة لما أجرت الانتخابات»، لتضيف أنها «في حاجة إلى الانتخابات كي تجمل مخالبها»! وحوصر الناس بضخّ أخبارٍ مسمومة مفادها أن الانتخابات لن تبدل شيئاً. واحتلت الشاشات من مدعي «قياس الرأي» الذين زعموا باسم العلم والإحصاء، أن الأكثرية محسومة والتنافس محصور بمقاعد قليلة، وسادت أجواء الترهيب التي أطلقتها الدويلة عندما اعتبرت «الانتخابات حرب تموزٍ سياسية»، لتخوِّن من سيخوض الانتخابات ضد «حزب الله» وقوائم «الحلفاء» التي تعهد نصر الله بفوزها! وهم على الأغلب استندوا إلى قانون هجين تم تفصيله، على قياس هذا التحالف، ليضمن تقاسم المقاعد بين أطراف «نظام المحاصصة الطائفي»، وفق وزن كل فريقٍ في طائفته، خصوصاً أن بدعة «الصوت التفضيلي» جوّفت النسبية وأغرقت خيارات الناخبين بالمذهبية!
جاء يوم 15 مايو (أيار) وانفجر الغضب، تصويت عقابي واسع في صناديق الاقتراع، فحملت الانتخابات صفعة مدوية لمشروع «حزب الله» وأتباعه، لم يوقفها لا تزوير ولا رشوة ولا بلطجة. وتجاوز المقترعون، الذين استعادوا أصواتهم مقولات قالت ما الفائدة من انتخابات ستعيد إنتاج شرعية «الحزب»، ليستكمل الانقلاب الذي بدأ مع التسوية الرئاسية عام 2016، وبعدها فوزه بالأكثرية النيابية عام 2018، ولم تأخذ أي جهة بعين الاعتبار وجود قوى جديدة وُلدت من رحم ثورة تشرين وقدمت للبنانيين خياراً آخرَ!
لم تطابق رياح الانتخابات، المخطط المرسوم للفوز بأغلبية الثلثين، لتشريع السلاح والقبض على رئاسة الجمهورية واستكمال اقتلاع لبنان وإلحاقه بـ«إيران الكبرى». أكثرية «حزب الله» التي كانت 73 نائباً تراجعت إلى 62 نائباً من أصل 128، وبات العمود الفقري للأكثرية الجديدة يجمع بين قوى تغييرية وقوى مستقلة وسيادية ومعارضة تقليدية خرجت على تسوية العام 2016 التي أوصلت ميشال عون إلى بعبدا، لقد حدث التسونامي وتبدل المشهد في البرلمان الجديد، والرفض الشعبي أسقط مشروع الدويلة، لكن التنبه ضرورة؛ فحجم الصعوبات كبير والعقبات كَأْدَاءَ، لكن يد الدويلة لم تعد مطلقة!
مع فرز الصناديق انفجر الفرح بفوز 15 نائباً جديداً أتوا من رحم ثورة «17 تشرين»، ممن لم يغادروا الساحات منذ انتفاضة النفايات عام 2015 إلى ثورة تشرين وما بعدها. هم افترشوا ساحات الثورة، ولم ييأسوا من انكفاء الناس تحت وطأة «الكوفيد» ثم المجاعة، ولم يُحبطوا من تهجير ناشطين غادروا ورأوا أن الأمل تلاشى، واستنتجوا أن الناس تأقلمت...، فتمسكوا ببذور التغيير التي ساهموا في زرعها. وعندما باحت الصناديق بمكنوناتها، تبين أن الكثير منهم حقق أرقاماً قياسية، فأسقط نواب التغيير الرموز المتبقية من حقبة احتلال النظام الأسدي، والذين تقدموا الصفوف دفاعاً عن تغول الدويلة. ومنهم إيلي الفرزلي المدافع عن «الحصانات» و«قانون الإفلات من العقاب»، وطلال أرسلان وأسعد حردان وكلاهما في النيابة منذ العام 1992، وفيصل كرامي الذي كان يتم الترويج لترؤسه الحكومة إلى بلطجي المصارف مروان خير الدين.
شكل الفائزون تياراً وطنياً عابراً للطوائف والمناطق، وهم ينتمون إلى 8 قوائم أساسية من أصل 12 قائمة مكتملة، أمّنت فوزهم كتلة ناخبة ضمت مئات ألوف المقترعين، عكست النسيج الوطني لثورة تشرين، وباتت قوى التغيير الناخب الأكبر في لبنان. ويبقى السؤال كيف حدث هذا التسونامي؟ وكيف خسر «حزب الله» أكثريته وأُسدل الستار على وجوه بارزة من أتباعه؟
لقد طالت جغرافيا الفقر كل البيئات، واتسعت الانتهاكات، وعموماً لم يستسغ الناس ضخ «المال السياسي» للرشوة، وشراء الذمم ببونات البنزين، ولا العودة إلى «كراتين الإعاشة» التي سادت أيام الحرب، والأسئلة كانت تتعاظم: أين ودائعنا ولماذا تم السطو عليها؟ وأين الضمانات البسيطة وإلى متى يحرم الناس من حقوق أولية مثل الكهرباء والمياه النظيفة؟ وباتت الخيارات دقيقة؛ مع أو ضد من أذل اللبنانيين؟ حرم المريض من حقه بالدواء والاستشفاء وتُرك مرضى السرطان إلى مصيرهم، وحرم المواطن من حق أولاده بالتعليم، وأطفال مئات ألوف الأسر ينامون من دون عشاء، والفقر الشديد طال 83 في المائة من اللبنانيين... وغابت المحاسبة، وتم الضرب عرض الحائط بالحقيقة والعدالة مع التعطيل التعسفي للتحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ.
الأكيد أن القوى الطائفية استخفت باتجاه حركة الناس، وبمواجهة التململ، عمدت إلى خطاب التحريض والتخويف من الآخر لإحداث استنهاض في بيئاتها، لكن نسبة معتبرة حسمت قرارها بالامتناع عن التصويت، ولم تنتقل كلية إلى دعم البديل الذي قدمته قوى التغيير، فحدث تراجع في نسب الاقتراع للقوى الطائفية، ولا سيما الثنائي المذهبي، ولولا التزوير والبلطجة لكان انكسار محور الممانعة أعمق وأكبر.
بات للبنان كوكبة نواب شجعان، يشبهون الناس، انتصروا بمواجهة مع قانون هجين، وسلطة منحازة متعامية عن الترهيب والتزوير، وفاز معهم من اقتلعت عيونهم، ومن أصيبوا بالمطاط واختنقوا بالغاز، ومن تم تخوينهم والتهديد بهدر دمهم لأنهم تجرأوا على المواجهة، وكل الذين ينشدون الحقيقة والعدالة في جريمة تفجير المرفأ... وهم عشية الاستحقاقات الكبيرة تحت أعين ناخبين سيحاسبونهم على كل خطوة أو مبادرة!
GMT 20:40 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
عندما يعلو صوت الإبداع تخفت أصوات «الحناجرة»GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟محمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض ـ العرب اليوم
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدالتطورات التكنولوجية في مجال زراعة الأسنان الرقمية ودورها في تحسين الرعاية الصحية للفم
القاهرة ـ العرب اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©