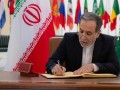الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
اللعبة مستمرة ولبنان آخر للبنانيين ما زال ممكناً!
اللعبة مستمرة ولبنان آخر للبنانيين ما زال ممكناً!

حنا صالح
بقلم حنا صالح
كان الاستنفار عاماً شاملاً عواصم المنطقة والعالم، فجر السادس من فبراير (شباط) الحالي، إثر الزلزال المروّع الذي ضرب بقوة تركيا وسوريا، وتأثرت به بلدان المنطقة. وأمام المشاهد المروّعة وتنامي الدلائل على توحُّد البشرية تحت شعار الإنقاذ، وبروز سلطات قادرة تدير الكوارث لحماية المواطنين، لازمَ القلق لبنان وأهله، وتضاعف مع الزلزال الثاني الذي وقع ظهراً، وقد افتقد اللبنانيون أي أثر جدي لدولتهم وسلطاتهم.
بدت ساعات الانتظار كدهر للمحاصَرين في منازلهم، فتيقنوا مجدداً من أنهم متروكون لمصيرهم. لا توجيه ولا «قصقوصة» ورق، وما قيل عن خطة مواجهة تداعيات الزلازل تبين أنها شكلية وأولية كان ينبغي أن تكون مُنجَزة مسبقاً، فرموا الكرة على بلديات مترهّلة لإجراء «مسوحات للمباني»... و«إبلاغ الهيئة العليا للإغاثة»! ويعلن وزير الداخلية أن «مالية الدولة ليست مسؤولة عن الترميم»، وينصح بإخلاء المتصدع، دون الإعلان عن بديل، في استسهال مخيف لترك الناس في العراء تحت أقسى موجة قطبية! ليتبين أن الهم الرسمي هو التبرؤ من المسؤولية، بعدما تأكد أن على مكتب معاليه مسح نقابة المهندسين لمدينته (طرابلس) الذي أظهر تصدع ألف منزل... إلى نحو 16 ألف منزل متصدعٍ في بيروت التي رمّد تفجير المرفأ ثلثها، هذا غير بقية المناطق!
مشهد صادم يعبّر عن منحى خطر، بحيث باتت أولوية المتسلطين توظيف المآسي المتدحرجة والبؤس لخدمة مصالحهم الضيقة ومشاريع تأبيد التسلط. استثمروا في إفقار البلد وفرض العوَز على أهله، وغطوا اختطاف «حزب الله» للدولة ليتبادلوا المنافع («موالاة» النظام و«معارضته»)، فتحاصصوا الوزارات والمؤسسات والإدارات؛ فكان الانهيار متعدد الأوجه: سياسي وأخلاقي، في ظلهما تم السطو على المال العام والاستئثار بجنى أعمار الناس، فتلاحقت الانهيارات المبرمجة؛ المالية والاقتصادية والاجتماعية.
لم يبدأ كل ذلك في السنوات الأخيرة التي شهدت تسريعاً مقصوداً للانهيار؛ فتاريخياً مَن تسلط على قاعدة العفو عن جرائم الحرب امتنع عن بناء مشروع الدولة. التحقوا بالخارج، واكتشفوا مصلحتهم في تعليق العمل بالدستور. ذهبوا إلى تمتين التسلط بـ«الحصانات» ومحاكم خاصة، وتثبيت «قانون الإفلات من العقاب»... وفي ذروة الانهيارات حددوا أولوية؛ بمحاولة قوننة العفو عن الجرائم المالية، حتى إن زيارة إلياس بو صعب، نائب رئيس البرلمان، إلى واشنطن، حملت عرضاً إلى «صندوق النقد» يقوم على تسييل أصول الدولة لتغطية الخسائر، حماية للكارتل المصرفي الناهب من الملاحقة والمساءلة، رغم أنه الطرف المرابي الذي قامر بالودائع؛ ما دمّر الثقة بالصناعة المصرفية! وهكذا الذين تسلطوا، استأثروا بالبرلمان وبالسلطة الإجرائية والإدارة، وقدموا مصالحهم الضيقة، صفقاتهم ونفوذهم، فأفرغوا السلطات من قوتها وهيبتها ومضمونها، ما سهَّل ابتكار أساليب السطو، مع التعامي المقصود عن تضخم الاقتصاد الموازي للدويلة، لتصبح الحصيلة إرسال أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين إلى حدود خط الفقر وما دونه!
وعندما تعرض لبنان إلى جريمة حرب في 4 أغسطس (آب) 2020، اتحدوا مافيا متسلطة لـ«محاكمة» المحقق العدلي الذي عينته حكومتهم؛ حكومة «حزب الله» التي رأسها حسان دياب! وبدأت تتتالى فصول الانقلاب السافر على القضاء والعدالة، بالتحالف مع رؤوس الأجهزة الأمنية، ورفع اليد من جانب وزارة العدل، بعدما تنكرت السلطة الإجرائية للحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ وبيروت! أسوة بتنكرها العملي لحقوق الذين نُهبوا، ليتم حرمانهم من إمكانية مقاضاة ناهبيهم!
رغم اتساع الأهوال، تروِّج بعض الجهات أن آليات الحكم يمكن أن تُستعاد وتكسر الحلقة المقفلة بمجرد انتخاب رئيس جمهورية غير محكوم باختيار «الثنائي المذهبي»! ويقفزون فوق الخلل الوطني وواقع البرلمان الذي لا يختلف كثيراً عن دور البرلمانات السابقة! ويقابل ذلك تصلب «حزب الله» الذي بعد رئاسة عون حدّد لنهجه 3 أقانيم: رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والسلاح، ضمانةً لهيمنته والمضي بمخطط قيام لبنان آخر أسوأ من الوضع الحالي، ويتعاطى بأريحية مع الخارج، لأنه ضمانة مصالحها النفعية!
منذ قُتل رئيس «الطائف»، رينيه معوض، لم تنتخب برلمانات ما بعد الحرب الأهلية رئيساً للجمهورية. لقد عمّ الشغور الرئاسي منذ عام 1990، عندما لم يُترك للبرلمان إلاّ البصم على مرشح وحيد كان المحتل السوري يقترح اسمه قبل عام 2005، وبعد عام 2008، فرض «حزب الله» مشيئته! ففي عام 2009، كما في عام 2016، «مُنعت» الأغلبية من إيصال مرشح لها رئيساً؛ مرة نتيجة الترهيب بعد احتلال القمصان السود للعاصمة وانعقاد «الدوحة»، وثانية بعد الاتفاق النووي، فنقلت قوى طائفية رئيسية البندقية من كتف إلى كتف، مفضِّلة إبرام صفقات محاصصة واستئثار مع التيار العوني، وفق مخطط «حزب الله»!
منذ «مؤتمر الدوحة»، اتسع دور «الحزب» نتيجةَ «فائض القوة» التي امتلكها، وكان الجهة التي تُجيز تأليف الحكومات التي تشكلت منذ عام 2009. ولم تقتصر قوّته يوماً على حجمه التمثيلي داخلها. لقد لعب الدور الأخطر موجّهاً للسلطة، فبدا لكل المنظومة الحارس المانع للإصلاح، فحاز رضا الآخرين، لأن خطوات الإصلاح، مهما صغرت، كان من شأنها أن تمسّ مصالح المتسلطين... ويستحيل عليه التبرؤ من النتائج الكارثية التي تسببت بها إملاءاته السياسية والاقتصادية على اللبنانيين! ورغم ذلك يريد بترشيحه سليمان فرنجية فرض الرئيس الذي يستنسخ مآثر عهد عون! أما التباهي بأنه الجهة التي قمعت «ثورة تشرين»، فالقراءة المتأنية تؤكد عجزه عن إخماد بقعة الضوء التي حملها مناخ تشريني تغييري، ففاجأته صناديق الاقتراع بالتصويت العقابي، كما في عدد النواب الذين دخلوا البرلمان لأول مرة ممثلين للثورة!
الظاهرة التي طرأت على تركيبة برلمان 2022، أدخلت متغيراً سياسياً نوعياً؛ فـ«تكتل التغيير»، هو الكتلة الخامسة من حيث عدد النواب، والأولى من حيث التصويت الشعبي، أسقط أكثرية «حزب الله»، ومنع خصومه من الاستحواذ على الأكثرية... وواقعياً خلط الأوراق بمعزل عن «زحطات» في أداء البعض نتيجة قراءة قاصرة، أو رغبةً بمصالح. ولم يكن استهدافهم خارج التوقع؛ فالهدف تشويه الدور لإحباط التجربة.
لكن، حتى في الاعتصام النيابي، رغم جانبه الاستعراضي، هناك حقيقة تكمن بتحديد الانقسام بأنه يدور حول الدولة والمؤسسات وليس أحجام الطائفيين ومصالحها الفئوية... ولا ردم لهذه الهوة إلاّ بالعودة للتشرينيين العاملين للتغيير، وبعودة هذا التكتل إلى مبادرته التي حددت البرنامج السياسي: قيام «الكتلة التاريخية» لتظهير البديل السياسي، وهو أمر متعذَّر مع قوى السلطة، ومستحيل بالتوافق معها، وغير ممكن من داخلها!
المشهد معقَّد، وأخطر منه مشروع رئاسة تقوم بكل شيء إلاّ حماية حقوق الناس والمصالح الوطنية. وحده المسار التشريني لفرض حكومة مستقلة تعيد تكوين السلطة يبقى أقل تكلفة على اللبنانيين الطامحين لاستعادة الدولة وتطبيق القوانين دون استنسابية، لتتأمن العدالة، وتُضمن الحقوق، وتحمى الكرامات، وتصان الحريات وحق الاختلاف، ويتأكد أن لبنان آخر يستعيد هويته وسيادته ما زال ممكناً!
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةمحمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض ـ العرب اليوم
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدالتطورات التكنولوجية في مجال زراعة الأسنان الرقمية ودورها في تحسين الرعاية الصحية للفم
القاهرة ـ العرب اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©