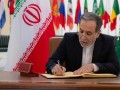الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
التفات القلوب خوفاً وحذراً
التفات القلوب خوفاً وحذراً

بقلم - جمعة بوكليب
الحنينُ إلى الحبيب أو الأحبّاء ليس جديداً. فمن لم يعد بمقدورنا رؤيتهم بالعين منهم، نحاول جاهدين ألا نجعلهم يختفون عن عيون قلوبنا. ولعل الشاعر الشريف الرضي أفضل من جسّد ذلك شِعرياً بقوله: وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب.
قبل تلك الحالة القلبية الوجدانية، عرفنا من تجاربنا وخبراتنا، أن التفاتة القلب خوفاً قد تعد أقدم الالتفاتات وأشهرها.
تذكرت ذلك خلال الأيام الماضية، وأنا أجوب شوارع وأحياء وطرقات العاصمة الليبية طرابلس الغرب، عقب أن وصلتها قادماً من لندن، للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك مع الأهل والأصحاب بعد غيبة طويلة نسبياً.
طرابلس التي عرفتها وعرفتني، طفلاً وصبيّاً وشاباً، ليست طرابلس التي عرفتها وأنا أدخل بقدمين مترددتين مرحلة الكهولة. المسافة الزمنية التي تفصلهما، قرابة أربعة عقود زمنية، تؤرخ في ذات الوقت لفترة غيابي عنها، وتوثق المصائر التي تقلبت بينها طرابلس، وما شهدته من أحداث وكوارث. لكنها في السنتين الأخيرتين تنفست الصعداء، واستمتعت بفترة استقرار نسبي، مقارنة بما شهدته خلال الأعوام الماضية. ومن المهم الإشارة إلى أن طرابلس الغرب تكاد تكون العاصمة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها مواصلات عامة. وهذا يعني أن شوارعها وميادينها تختنق بحركة المرور، من كثرة ما يوجد بها من سيارات خاصة. أضف إلى ذلك، أن المدينة في السنوات الأخيرة شهدت موجات نزوح وهجرة. النازحون جاءوها من مختلف مناطق ليبيا، وبخاصة من الشرق الليبي. والمهاجرون جاءوها من بلدان أفريقية وآسيوية، آملين في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي. الزائر للمدينة لا تفوته كذلك ملاحظة الحضور الأمني في شوارع وأحياء المدينة. ذلك الحضور قد يكون باعثاً على الثقة بين السكان، إلا أنّه من ناحية أخرى، ربما يوحي، وبخاصة للزائر غير المقيم، بأنّه تعبير عن خوف كامن، لدى الجهات الرسمية، من حدوث انتكاسة أمنية مفاجئة.
ومهما تختلف وجهات النظر حول الوجود الأمني المكثف، إلا أنّه، من دون أدنى شك، يشكل ردعاً لأي تفكير أو محاولة لإحداث انتهاك أمني، ويمنح المواطنين شعوراً بالأمان نسبياً. نسبية الإحساس بالأمان نابعة من كونه تأكيداً على عدم عودة الحياة إلى اعتياديتها.
مع اقتراب أيام عيد الأضحى تزايدت حيوية الأسواق في المدينة بشكل ملحوظ، واكتظت طرقاتها بحركة السيارات بمختلف أنواعها، إلى حد الاختناق، وبدا وكأن سكان المدينة على كامل الاستعداد لاستقبال العيد.
لكن، رغم ذلك، فإن ذلك الإحساس بالاستقرار النسبي، والشعور بشيء من الأمن والأمان، لا يشكلان، في حقيقة الأمر، وفي رأيي أيضاً، حاجزاً بين القلوب والالتفات للخلف خوفاً. نعم، هناك في حنايا قلوب سكان العاصمة الليبية منطقة ما زالت في حالة تأهب وحذر. منطقة، لا يمكن تجاهلها، ولم يصلها بعد الشعور بالاطمئنان والاستقرار. ولذلك السبب، تكثر القلوب من الالتفات إلى الخلف خوفاً من حدوث أي طارئ، أو خوفاً من عودة الماضي. ذلك الخوف ليس خارجاً عن إطار التوقع ولا مفاجئاً. وهو حاضر، ويمكن رصده في الأحاديث، وفي نظرات العيون، وفي أدعية المصلين بالمساجد، وفي التكبير المتواصل عبر مكبرات الصوت من مآذنها في فترات المساء والليل.
يظل الإحساس بالفرح بالعيد واطمئنان النفوس بالسلام والاستقرار ناقصاً، لأن الأمور وإن بدت على السطح هادئة ومستقرة، إلا أن ذلك الهدوء ليس عادياً، وأن الاستقرار ليس في وضع الثبات، كونه ممزوجاً بحذر وبخوف. الحذر من مغبة الانزلاق نحو حرب أخرى. والخوف من مغبة ما قد تقود إليه من تداعيات.
GMT 20:40 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
عندما يعلو صوت الإبداع تخفت أصوات «الحناجرة»GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟محمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض ـ العرب اليوم
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدالتطورات التكنولوجية في مجال زراعة الأسنان الرقمية ودورها في تحسين الرعاية الصحية للفم
القاهرة ـ العرب اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©