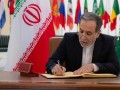الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
لا مبالاة
لا مبالاة

بقلم - سوسن الأبطح
يجهد المرشحون للانتخابات النيابية اللبنانية، لحث المواطنين على الاقتراع. كان الطلب في السابق: «اقترع لي». صار المرشح لا يعرف كيف يقنع الناس بمجرد التحرك والذهاب إلى المراكز الانتخابية. في مقابل حماسة المرشحين وغليانهم، ثمة برود غير اعتيادي من قبل الناس. كثر ممن يسكنون بعيداً، يستخسرون دفع ثمن البنزين الذي يقلهم إلى مركز الانتخاب، ويطالبون بثمنه من المرشحين، مما استدعى تخصيص باصات، من قبل البعض.
نصف اللبنانيين لم يذهبوا إلى الصناديق في الانتخابات السابقة عام 2018، علماً بأن الظروف كانت أفضل مائة مرة. اليوم تقول الإحصاءات، إن نصف الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، وربما أن العدد أكبر رغم أن أياماً فقط تفصلنا عن الاستحقاق.
لهذا تبدو كل التوقعات حول النتائج، مجرد قراءات في النيات. عزف اللبنانيون بشكل كبير عن متابعة المنازلات التلفزيونية بين المرشحين. يبدو الكلام مكروراً، ومضجراً، ومجرد تعبئة فراغ. أناس يتقاذفون التهم، ويعجزون عن تصور حلول. الأموال التي يدفعها المرشحون للأقنية التلفزيونية لظهور إعلاني ترويجي، ربما أنها لا تثمر كما يودون، فالناس في وادٍ آخر، وكثافة الصفحات الانتخابية على وسائل التواصل، وكثرة المجموعات، لم تسعف إلا في زيادة المشهد ضبابية.
وصلت هشاشة الشعارات إلى حد أنك لا تحفظها، أو حتى تنتبه لوجودها. مشهد الصور الكبيرة الملونة، التي كانت تلفت الناخب، باتت تشعره تكاليفها بالغثيان والصدود. حقاً، ليس من المناسب إظهار المرشح قدرته على الدفع، فيما المواطن يجد أن ربطة الخبز تتجاوز ميزانيته.
تعدد اللوائح في الدائرة الواحدة، مع غياب كبير للأسماء المعروفة في بعض الدوائر، لم يقنع الناخبين بالوجوه الجديدة، التي عجزت عن قول شيء مختلف. فهي إما استنساخ لزعيم، أو راغبة فعلاً في التغيير لكنها لا تملك الخطاب ولا الأدوات. في دائرة بيروت الثانية 10 لوائح على الناخب أن يختار واحدة منها، في الشمال الثانية التي تضم مدينة طرابلس النسبة الأعلى، 11 لائحة، وثمة دوائر ترشح عنها 7 أو 5 لوائح. ينظر الناخب إلى الأسماء فيجد نفسه أمام غمامة كثيفة. منهم من يسأل، من هؤلاء؟
هذا لا يعني أن الصناديق لن تحمل تغييراً، بل يعني أن اللبنانيين في حالة إحباط كبير، وهم محقون.
فالمرشحون الجدد يشبهون القدامى حتى في افتقار خطابهم لبرامج ذات مصداقية. يضاف إلى ذلك قانون انتخابي معقد، نسي الناخبون تفاصيله، التي شرحت لهم قبل أربع سنوات. حتى اللحظة لم تتبرع سوى مجموعات إنترنتية صغيرة، بجهود ضئيلة لشرحه مرة ثانية. بمعنى آخر، ثمة من لا يعرف، كيف يختار، ولا وفق أي صيغة، علماً أن 2 في المائة من الأصوات في المرة السابقة ألغيت بسبب أخطاء في الاقتراع، وكانت جهود جبارة قد بذلت في التوضيح.
التعويل على اندفاع المغتربين، قد يكون مبالغاً فيه. تُطرح على شبان يعملون في تنظيم انتخابات المغتربين التي ستتم في عطلة الأسبوع المقبل، أسئلة من نوع: «في أي يوم سيكون التصويت؟»، و«هل حقاً، يجب أن نذهب إلى مركز ما، أم سيتم ذلك عبر الإنترنت؟». وتأتي الاستجابة غالباً، على مجموعات «واتساب» عند التشديد والإلحاح: «سأحاول».
وأدت السلطة اللبنانية إلى جموح الشعب اللبناني للتغيير في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بطرق شتى، أهمها ركوب الأحزاب السياسية التقليدية موجة الاحتجاج، واعتبار نفسها جميعها، أم الانتفاضة وأباها. تفتت الحركة الاحتجاجية، انضواء بعضها تحت ألوية أحزاب تقليدية وكأنها تعود إلى عرينها، اختلاف من بقي من المحتجين بين بعضهم البعض وتشتتهم في لوائح متضادة، بسبب الأنانية المفرطة وعشق السلطة، عدم قدرة الحركة المعارضة الحقة على بلورة برنامج جامع، والأهم ظهور العديد من هؤلاء كمنتفعين من أموال خارجية، وحسابات ليست بالضرورة وطنية. ظواهر ارتدت قلة ثقة بحركات كان يفترض أن تعكس مواطنة نزيهة، واضحة وجلية. يذهب المواطنون، هذه المرة، ليس لاختيار الأفضل، وإنما للأقل سوءاً.
تجري الانتخابات، على وقع أخبار الاختلاسات والادعاءات الغربية على حاكم مصرف لبنان، وفضائح التلزيمات، التي بات المواطن ينتبه لتفاصيل المعارك الروسية - الأوكرانية، أكثر مما يجد جدوى في متابعة تعقيدات أقنيتها ودهاليزها.
انتخابات فوضوية، بعض السلطة فيها ضد البعض الآخر، وبعض الحركات الاحتجاجية ضد البعض الثاني، والناس مشغولون بتأمين بضع ساعات من التيار الكهربائي بمبلغ باهظ حتى بالقياس لأوروبا، ويمنع الموظف من سحب راتبه الزهيد إلا بالقطارة في المصارف، ويهدد بقطع الإنترنت في أي لحظة، بعد أن باتت كهرباء الدولة في علم المجهول، وترتفع الأسعار بنسب جنونية يومياً. ليست الانتخابات أولوية لأحد باستثناء الحزبيين المستشرسين، وبعض المنتفعين. هل سيذهب المواطنون إلى الصناديق؟ أجازف وأقول، بنسبة ليست بكبيرة، إلا إذا تحرك المال الانتخابي، بما يغري مساكين الناس ببيع أصواتهم.
بحسب «الدولية للمعلومات» التي أجرت دراسة حول الرشى الانتخابية، فإن سعر الصوت، يصل إلى 300 دولار في بعض الدوائر مثل بيروت الثانية، في بلد منهار اقتصادياً، وقد يبلغ أرقاماً قياسية قبل إغلاق صناديق الاقتراع، فيما السقف القانوني للمرشح يجب ألا يتعدى 6 آلاف دولار. واعترف أحد المرشحين أن ما دفع من رشى كان بمقدوره أن يفتح عشرات المصانع التي تحل أزمات الناس.
تلك ليست ديمقراطية، وهذه الممارسات لا تسمى انتخابات، بل شراء ذمم، وبيع ضمائر. وإلى أن يحين موعد «الديمقراطية» الحقة، نحتاج إلى شوط طويل من التأهيل، وحرب مخلصة كفؤة، على زعماء التفقير والتجويع.
إنها انتخابات ليست كالانتخابات.
GMT 13:05 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
حزب الله بخيرGMT 11:57 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مرحلة دفاع «الدويلة اللبنانيّة» عن «دولة حزب الله»GMT 11:55 2024 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر
هل هذا كل ما يملكه حزب الله ؟؟؟!GMT 20:31 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
عشر سنوات على الكيان الحوثي - الإيراني في اليمنGMT 20:13 2024 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
صدمات انتخابيةمحمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأحلام تطلق ألبومها الجديد "العناق الأخير" وتعرض مفاجآت تعكس عصارة 30 عامًا من الإبداع الفني
أبوظبي - العرب اليوم
الفنانة أحلام أفرجت أخيراً عن أغاني ألبومها الجديد "العناق الأخير"، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم وبعد فترة من تشويق الجمهور إليه، وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجآت غير متوقعة في ألبومها الجديد والذي تفتتح به �...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©