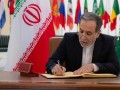الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
فساد حتى القتل
فساد حتى القتل

بقلم - سوسن الأبطح
كان لا بد أن يموت فنان مشهور مثل جورج الراسي، كي تتحرك فرقة من وزارة الأشغال، لتكشف على طريق رئيسي قاتل، على الحدود اللبنانية - السورية، وتفكر في اتخاذ إجراءات، تحفظ حياة الناس، علماً بأن الخطورة كانت واضحة للعيان، على مدى سنوات، والأخطاء التقنية لا تغتفر. الأنكى، أن حوادث متكررة وضحايا عدة سبقوا الراسي وقضوا على نفس الحاجز الإسمنتي الذي يتوسط طريقاً سريعاً، يظهر للسائق فجأة، بما لا يسمح له بتدارك الكارثة، ومع ذلك لم يتحرك أحد.
على شاكلة حاجز الموت الإسمنتي هذا الذي لم يحذّر منه بضوء أو يُطلى بلون فوسفوري، ولم توضع أمامه أي دعائم لحماية السائق وتخفيف الصدمة، في حال الارتطام، حواجز أخرى مماثلة متروكة بالعشرات لتصطاد ضحاياها، أشهرها في ظهر البيدر؛ إذ يعوّل المسؤولون، رعاهم الله، على أن العابرين، يفترض أن يحفظوا الطرقات غيباً، ومَن لا يفعل، فهذا ذنبه، وليذهب إلى الجحيم. قد تقابلك، على حين غرّة، إطارات سيارات، سدت بها المجارير الصحية، التي سُرقت أغطيتها. وبالطبع بدل محاسبة سرقة الخردة وتجارها، وسجنهم لما يتسببون فيه من مخاطر للسيارات العابرة، تسد الفجوات بدواليب مستعملة، بانتظار أمر ما. وكل ما في لبنان بات مؤقتاً، وسياسة الترقيع تبدأ من الرأس، ولا تنتهي بتأمين متقطع للقمح، أو البنزين والمازوت. التخطيط للمستقبل حتى القريب، ليس من شيمنا.
جمعية «يازا» لسلامة السير، بحّ صوتها وهي تشير إلى مكامن الخلل على الطرقات، وتلفت إلى ضرورة القيام بإجراءات صغيرة، وغير مكلفة، للحد من عدد الوفيات المتصاعد. في شهر أغسطس (آب) وحده، مات خلال 20 يوماً 42 ضحية، ليتبين أنه الشهر الأكثر دموية. نحن نتحدث عن بلد لا يستطيع أهله دفع سعر البنزين، وانخفض السير بشكل ملحوظ. وللغرابة، كلما قلّ عدد السيارات المتجولة في الشوارع ارتفع عدد الموتى، لأن متعهدي الغفلة، في الأصل وقبل الانهيار، لم يقوموا بعملهم بما يرضي الضمير، فأتت السنوات العجاف، لتكشف عن فساد من نوع آخر، هو الإخلال الفاضح بشروط التلزيم، وسكوت المسؤولين عن المتعهدين، وتدليلهم على حساب المواطنين المساكين. تتكاثر الحفر بسرعة، وتتفتق الطرقات، عن عورات تزفيت شكلي وهشّ، لا يصمد أمام الأمطار وحركة السيارات. لا تريد أن تصدق أن عشرات مليارات الدولارات التي صرفت على البنية التحتية، تبين بعدها بلد بلا مجارير ولا مواصلات عامة، ولا شبكة إنترنت فاعلة، ولا حتى مصارف محترمة، كانت تقدم نفسها، ذات يوم، كفخر للصناعة اللبنانية العريقة.
الفساد يفقر، لكنه يقتل أيضاً، وإذا أضفت إليه اللامبالاة، تصبح في وضع لا تحسد عليه. غالبية الشوارع بحاجة إلى قليل من الطلاء الفوسفوري الذي يدلك على جانب الطريق، أو منتصفه. قليل من الدهان قد يحميك من النزول إلى وادٍ سحيق، أو ينقذك من عمود كهربائي. توفير حياة بسطل طلاء، أمر يستحق التحرك من أجله. ليست المهمة شاقة إلى هذا الحد!
الإضرار بالمواطنين وتعذيبهم، يبدو كأنه متعمد، هذا شعور سائد عند عامة الناس؛ إذ كيف يتمكن كائن عند زاوية الحي يملك مولداً متواضعاً ومتهالكاً، أن يحصل على المازوت حين يشاء، ويزود السكان بالكهرباء، ولا تستطيع دولة لها معامل وقدرات أن تشتري المادة نفسها، مع أن بإمكانها لو فعلت أن توفّر التيار الكهربائي بنصف السعر، ولا تفعل. أكثر من 250 دولاراً تدفع العائلة الواحدة مقابل عشر ساعات كهرباء، هي تكلفة تفوق ما تدفعه عائلة بريطانية متوسطة لتنعم بدفء الشتاء، والكهرباء بلا انقطاع.
لا يشتكي الأهالي، بالقدر الكافي، من دخان المولدات التي تنفث سرطانها في أجسادهم. منشغلون هم الآن بتدبير ربطة الخبز، وحطب الشتاء، وحاجتهم من الماء، لكن أقسام العلاج الكيميائي في المستشفيات الكبرى، تشي بكارثة الأعداد الغفيرة للمصابين وصغر أعمارهم. بالطبع ليس هذا وقت البحث، فمصيبة تحجب أخرى، والضوء يسلط الآن، على مأساة حرمان من يعانون النزع الأخير من مادة المورفين، التي تسمح لهم بأن يرحلوا بشيء من هدوء وسلام. حتى المورفين استكثروه على العباد، وتوقفوا عن استيراده بحجة شح الدولار. كيف لبلد صغير، يتجاوز مصروف السياح على أرضه ثلاثة مليارات دولار في شهرين، تقرر دولته أن تبقى خارج دورته الاقتصادية، تعطّل مرافقها، تشل مشروعاتها، وتنتظر التسوّل من هنا، ومنّة تافهة من صندوق النقد الدولي.
الدواء ترف، والمستشفيات نعمة لا يحظى بها سوى المقتدرين، بعد أن أفرغت صناديق التأمين من محتواها، وتركت اسماً بلا معنى ولا وظيفة.
هذه ليست مقالة لبث الشكوى وبعث الألم في النفوس، بل فقط للقول إن موت نجم بحادث سيارة ألقى الضوء على كارثة الطرق، التي تذكّر بما كانت عليه حال البلاد بعد الحرب الأهلية. مع أن لا شيء يبرر تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم، ولا برود الحكومة عن الإسراع بإجراءاتها، سوى أن يكون المواطن مستهدفاً بحياته ورزقه وأولاده؛ حيث يضطر الأبناء للهرب من الفاقة والبطالة، وتستمر البنوك في نهش أموال المودعين بمنتهى الصفاقة، وتتفرج الدولة على مواطنيها عراة إلا من صبرهم الذي لا ينفد. وهذا لعمري من عجائب الدنيا.
GMT 20:40 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
عندما يعلو صوت الإبداع تخفت أصوات «الحناجرة»GMT 06:23 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
المبحرونGMT 06:20 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
قرارات أميركا العسكرية يأخذها مدنيون!GMT 06:17 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
تسالي الكلام ومكسّرات الحكيGMT 06:14 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
كيف ينجح مؤتمر القاهرة السوداني؟محمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض ـ العرب اليوم
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©