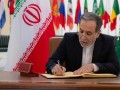الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الجزيرة الملتهبة
الجزيرة الملتهبة

بقلم - سوسن الأبطح
ثمة اعتقاد أن الحرب الكونية الثالثة، إذا ما قدّر لها أن تقع فسيكون ذلك بسبب اشتباك في بحر الصين والمحيط والمحيط الهادي بين أميركا والصين، بعد أن بلغت الحرب التجارية ذروتها، والاستعراضات العسكرية حداً من الخطورة. ويغادر الجيش الأميركي، كل نقاط تمركزه القديمة دون أسف، وليس له من همّ سوى رد شبح الأخطبوط الصيني.
علماً أن الصين، تعيش فترة انتقالية، هي في أمس الحاجة خلالها، إلى الهدوء وإعادة تنظيم هياكلها. فأزمة «كورونا»، بقدر ما أفادت الصين اقتصادياً، دفعتها أيضاً إلى تشغيل مصانعها فوق طاقتها. فالعمل بزخم منهكٍ لسدّ الحاجات التجارية المتفاقمة للشعوب، يوم قبع الجميع في المنازل، ربما كان وراء أزمة الطاقة التي تركت مناطق صينية بأكملها بلا كهرباء، ومصانع مشلولة الإنتاج.
العالم بأسره، يعيد تنظيم نفسه بعد الجائحة، والأزمات لا توفر العمالة. أميركا ليست بمنأى، كما أن الصين تعود إلى اشتراكية قاسية، بهدف الحدّ من تنامي الثروات الفردية، التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة. فالشعار الآن هو «الازدهار للجميع»، وليس لفئات من دون غيرها، بعد أن تحقق هدف القضاء على الفقر. ولن تكون رحمة بمن يراكمون الثروات، مثل إمبراطور «علي بابا» جاك ما الذي اضطر لدفع 13 مليار دولار، كما غيره من المستثمرين الكبار. فالغاية هي الاحتفال بمئوية تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 2049 وقد عمّ الخير، لكن الطريق لا يزال طويلاً، لهذا تبدو القرارات الصارمة حاجة أكثر من أي وقت مضى.
مع ذلك فالتحفز الأميركي - الصيني على أشده. لا أحد يريد الحرب، لكن الجميع يتوجس منها. فأي خطأ أو انزلاق قد يؤدي إلى نتائج كارثية. ويعتقد أن تايوان هي واحدة من أكثر المناطق خطراً في العالم، بسبب موقعها، والاستشراس عليها.
الأسبوع الماضي، ظن البعض أن الحرب بين القوتين الكبيرتين قاب قوسين، بعد أن نشرت الصين فيلماً فيه محاكاة لغزو جنودها لجزيرة تايوان التي ترى فيها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واستعادتها حتمية، مما أثار الرعب وحبس الأنفاس، فيما لا تتوقف أميركا عن تسليح التايوانيين بأحدث المعدات وتدريبهم، وتصعّد في تصريحاتها لتأكيد حمايتها للديمقراطية التايوانية، ما يرى فيه الصينيون استفزازاً غير مقبول لمسألة داخلية تعنيهم وحدهم. بلاد التنين لا تسكت عن التمترس الأميركي حولها في البر والبحر، وعقد الاتفاقات والتحالفات العسكرية التي تستهدفها. فقد نفذت أكثر من 600 طلعة لطائرات مقاتلة في مناطق جوية تايوانية منذ بداية العام، كما أنها أقامت جزراً صناعية في المياه، حولتها إلى قواعد عسكرية، تحسباً للآتي.
تايوان جغرافياً وثقافياً جزء من الصين، كما هونغ كونغ. تأسست حين هرب القوميون من الصين باتجاه الجزر المحاذية لها، بهدف العودة يوماً إلى بلادهم وتحريرها من يد الشيوعيين. كان ذلك في أول أكتوبر (تشرين الأول) عام 1949 يوم انسحب بعض المسؤولين العسكريين والإداريين من الكومينتانغ، على رأسهم الزعيم القومي شيانغ كاي شيك أمام تقدم قوات زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ، وتحصنوا في تايوان إثر هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية، وأسسوا ما سموه «جمهورية الصين الوطنية» على مجموعة من الجزر أكبرها تايوان. ومن يومها تنظر الصين إلى الهاربين من كنفها كحالة انفصالية، يتوجب إنهاؤها. لكن الحياة أخذت التايوانيين إلى مسار آخر، بحيث تحولت بلادهم إلى واحدة من أهم دول العالم بسبب اجتهادهم، وعبقرية خياراتهم.
هذه الأرض الزراعية الفقيرة، التي تعتمد على إنتاج قصب السكر والأرز والبطاطا، وتعيش من المساعدات المالية الأميركية، تمكنت من التقاط اللحظة المناسبة، ودخلت عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه منذ ثمانينات القرن الماضي، يوم أسست واحداً من أهم مراكز الأبحاث العلمية، وحددت هدفاً هو التفوق في صناعة الرقائق الإلكترونية. بمرور الوقت صارت شركتها «تي إس إم سي» جوهرة التاج في هذه الصناعة، تصدرها للصين كما أميركا وبقية المعمورة، ومن دونها تشل الجيوش، وتنهار وسائل الاتصال، وتتوقف الطائرات، ولا تعمل هواتف نقالة. فصارت مقصداً لكل الشركات التكنولوجية الكبرى، ونقطة ضعفها. هم يصممون ما يريدون، وهي تنفّذ مع صيانة حقوق تصاميمهم. وتلك ميزة لم تكن متوفرة من قبل.
تتذرع أميركا في دفاعها عن تايوان بأنها نموذج ديمقراطي، فيما هي حليفة قديمة، عاشت تحت سطوة الديكتاتوية 40 عاماً. عمر الديمقراطية في الجزيرة الملتهبة لا يتجاوز العقدين. لكن الأهم أنها لا تبتعد عن الشواطئ الصينية سوى 180 كيلومتراً وتشكل تحدياً كبيراً لدولة عدوة هي في طور النمو والتعملق. سبعون سنة لم تكن الحياة هادئة ولا علاقة تايوان هانئة مع الصين، مع ذلك صنع التايوانيون المعجزات. ولا يبدو رغم كل ما يقال عن نذر الحروب، أن الصين ستنقض حربياً على أختها الصغرى بل ستنتظر لحظة سقوط الثمر ناضجاً. فثمة اعتقاد أن توحيد الصين سيتحقق سلمياً، لحظة تشعر تايوان أن لها مصلحة في العودة إلى الحضن الأم.
فالمشكلة بين الصين وتايوان، ليست في نكران الهوية، بل في المباهاة بمن هو أكثر أصالة، وقرباً من الجذور، وإخلاصاً للأرض والتراث؛ إذ لم تتخل تايوان يوماً عن النهج القديم في الكتابة الصينية، واحتفظت لنفسها بالخط الذي كان معتمداً قبل الثورة الماوية، وبالكتابة من فوق إلى تحت، ومن اليمين إلى اليسار. علماً أن الصين نفسها عمدت إلى التبسيط وتغيير الخط وجعل الكتابة من اليسار إلى اليمين، وتخلت عن بعض التعقيدات للتيسير.
وإذا كان من تعويل للصين على إعادة تايوان إلى حضنها، من دون حروب وسفك دماء، فذلك للإيمان الكبير بأن الثقافة الواحدة التي تربط بين أرواح البشر، تبقى أقوى من الخلافات السياسية الضيقة، وصراعات الأنظمة العابرة.
GMT 03:41 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلثا ميركل... ثلث ثاتشرGMT 03:35 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
مجلس التعاون ودوره الاصليGMT 03:32 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
عندما لمسنا الشمسGMT 03:27 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
ثلاثيّ العجز عن سيطرة العقل في لبنان: «كورونا» والدولار و«حزب الله»GMT 03:18 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر
رسالة إلى دولة الرئيس بريمحمد بن سلمان يكشف لترامب الرغبة باستثمار 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع
الرياض ـ العرب اليوم
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "نقل سم...المزيدأحلام تطلق ألبومها الجديد "العناق الأخير" وتعرض مفاجآت تعكس عصارة 30 عامًا من الإبداع الفني
أبوظبي - العرب اليوم
الفنانة أحلام أفرجت أخيراً عن أغاني ألبومها الجديد "العناق الأخير"، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم وبعد فترة من تشويق الجمهور إليه، وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجآت غير متوقعة في ألبومها الجديد والذي تفتتح به �...المزيدتيك توك يواجه خطر الإغلاق في أميركا وسط ضغوط قانونية وأمنية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها قد توقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية تحمي شركات مثل "أبل" و"غوغل" من تداع�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©